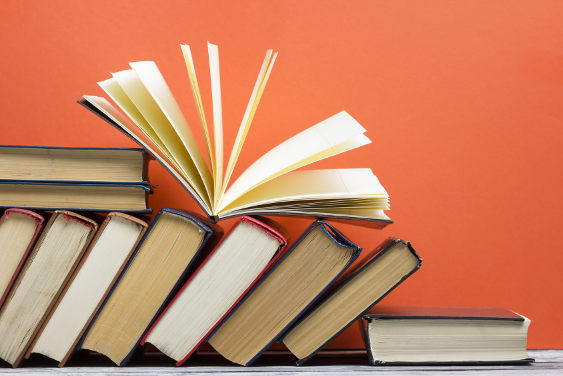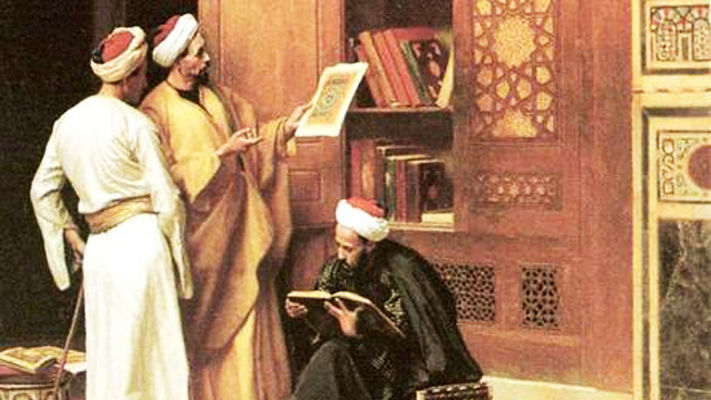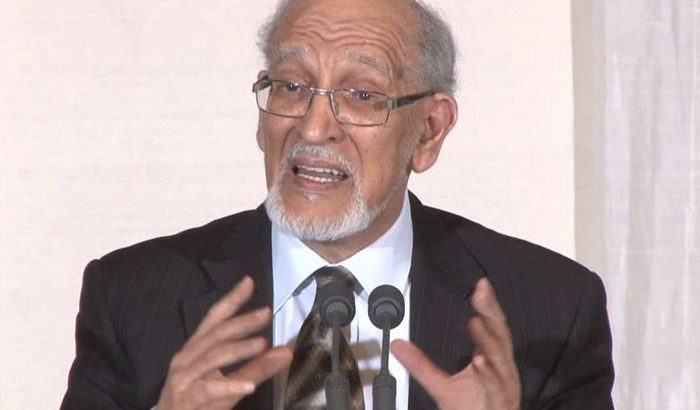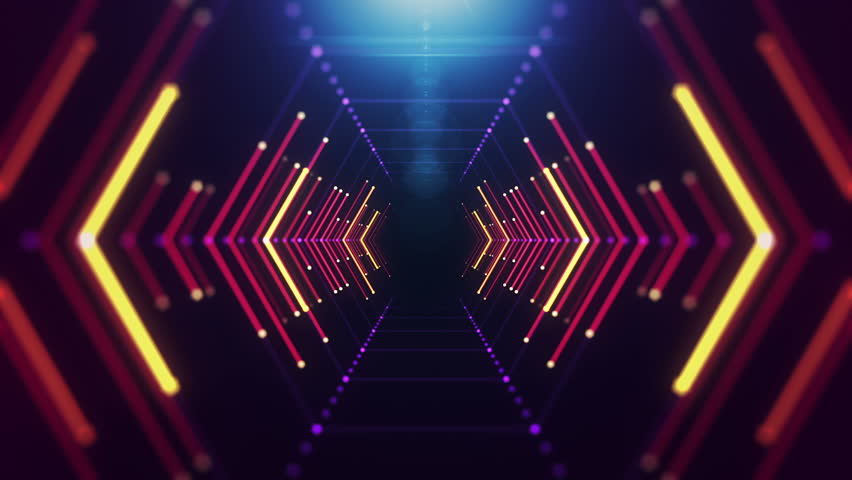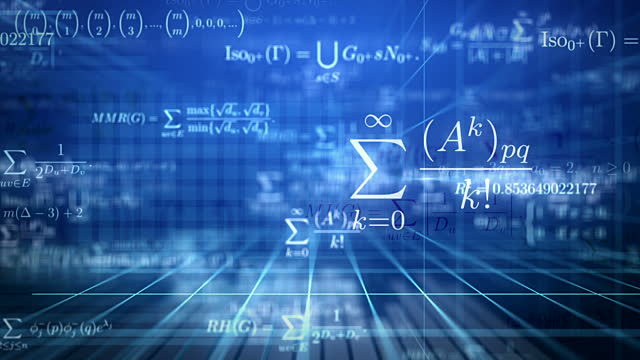لقد عبر القدامى من العرب والمسلمين عن إشكالية الترجمة، بشكل يٌظهِر وعيهم الكامل بها ودرايتهم العميقة بصعوباتها، فلا يخلوا تأليف من تواليفهم، في مجال من المجالات من ذكرٍ أو إشارة لها، تٌظهر مدى مالقيته عندهم من حفاوةٍ واهتمامٍ.
لذلك نقترح الوقوف على جوانب من ذلك الاهتمام، من خلال نصوص لنموذجين في فكرنا العربي والإسلامي هما الفارابي وابن تيمية.
1-الرابطة المنطقية وإشكالية الترجمة:
يقول الفارابي(260ه339ه/874م950م): "فلما انتقلت الفلسفة إلى العرب واحتاجت الفلاسفة الذين يتكلمون بالعربية ويجعلون عباراتهم عن المعاني التي في الفلسفة وفي المنطق بلسان العرب، ولم يجدوا في لغة العرب منذ أول ما وضعت لفظة ينقلون بها الأمكنة التي تستعمل فيها » أستين « في اليونانية و » هست « بالفارسية فيجعلوها تقوم مقام هذه الألفاظ في الأمكنة التي يستعملها فيها سائر الأمم، فبعضهم رأى أن يستعمل لفظة » هو « مكان » هست « بالفارسية و » أستن «باليونانية". (كتاب الحروف، ص122) إن هذا النص يلخص وبعمق الإشكالية اللغوية في ترجمة الفلسفة عند العرب والمسلمين، والتي رافقت مسيرة التفلسف عندهم، بداية باكتشافها لدى الأمم المجاورة، ثم انبعاث حركة النقل والترجمة، وتميز هذا الجو الذي رافق تشكل فكرنا الفلسفي العربي والإسلامي، معاناة مشاكل الترجمة وصعوباتها وما تخلفه من إضطراب في المعاني وإشتراك في الأسماء، والأمثلة كثيرة لمصطلحات عجز تراجمنا وفلاسفتنا عن إيجاد لفظة لها بالعربية.